|
تعود
((بداية أدب الأطفال)) في الزمان إلى أول الزمان، وذلك منذ أن تكاملت قدرة الانسان
على التعبير، وأخذت الأمومة والطفولة البشرية تسلكان طريقهما المرسوم نحو تكوين أسر
وجماعات. ثم انحدر في مسيرته مع الأيام على وجدان الصغار، وتهفو إليه آذانهم
استمتاعاً وترويحاً وتسلية، واستوعبه ضمير الجماعة، ليحقق به كثيراً من مواقفه،
ويرسب جانباً كبيراً من عواطفه ومعارفه. واحتفظت به ذاكرة الزمن ليسهم بنصيب كبير
في نقل تراث البشرية وخبراتها من جيل إلى جيل. وخلال التطور الانساني المبكر، كانت
القصص ـ وهي مادة الحياة ـ سواء رويت للكبار أو حكيت للصغار، وسيلة لتقاسم الخبرة
والتعليم، ولوناً رفيعاً من ألوان الإمتاع والمؤانسة.
والمجتمعات الانسانية
القديمة لم تكن تهتم بالطفل إلا بالقدر الذي يؤهله كي يكون قادراً على تحمل
مسؤولياته تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، ولم تكن مرحلة الطفولة عندهم مرحلة مهمة في
ذاتها أو مستقلة بمفردها، بل مرحلة انتقال تعبر بالكائن الصغير إلى مراحل الشباب
والنضج والرجولة. ومن ثم لم تكن هذه المجتمعات القديمة تعامل الطفل أو تنظر إليه
خلالها غلا على أنه راشد صغير، وكانت تتصور أن ما ينطبق على الراشد ينطبق على الطفل
سواء بسواء. ومن هنا لم تفرد الأطفال بأدب خاص بهم ينشئه لهم فنانون يبدعون خلقه،
بل بسطت لهم حكايات الكبار من خرافات، وأساطير، وحكايات الحيوان، والجن، وقصص
التاريخ أو الحرب والبطولات.. إلى غير ذلك من القصص التي ابتكرها الانسان الكبير في
تاريخه الطويل.
وعاش أدب الأطفال عالة على التراث الأدبي للكبار، يتخذ منه مصادر
يغترف منها المادة والصورة والخيال. وكلما تطور التفكير الانساني وتطور فئة الأدبي،
تطورت معه حكايات الصغار لتصبح هي الأخرى جزءاً من مادة الحياة، ووسيلة اتصال
أساسية للبشرية، وسبيل الأجيال المتعاقبة لنقل الأفكار والقيم الروحية والمثل
ومستويات السلوك والتقاليد. وصارت حكايات الأطفال كالجدول ينساب في موازاة النهر
العظيم من قصص الكبار ليستمد منه الحياة.
عندما تغير وجه الصورة:
وعلى الرغم
من أن الأطفال العرب ظلوا طوال العهود المزدهرة من الدولة العربية محرومين من الأدب
الرفيع المؤلف لهم خاصة إلا أنهم عاشوا في فيض مبسط من قصص الكبار التي زخر بها
المجتمع العربي، شعبية رائعة ومؤلفة مبتكرة، نتاجاً للعقلية العربية التي منحت حظاً
موفوراً من الخيال، وأعطت القدرة على صياغة المادة المحيطة بها قصصاً جميلاً،
وامتازت بالموهبة المبدعة التي تعيد تأليف القصص القديمة المتوارثة وتخرجها في فن
يكاد يكون جديداً، والتي تستقبل الحكاية المنقولة إليها بحفاوة وتقدير، وتصوغها من
جديد بمهارة ودربة فائقتين، وتضيف إليها روحها العربية، وتضفي عليها الكثير من
موهبة الخيال والفن التي تتملك ناصيتها، فلا يملك التاريخ إلا أن ينسبها إلى العرب
وينسى مصدرها الأول.
لم يعد العربي يشعر بذاته بعد النكبات المتوالية التي
اصطلمته (مغول، صليبيين، استعمار)، وابتعد عن الحياة العامة فتجمد وتخلف، وأصبح
يعيش في ظلمة الجهل وظلمة الاستبداد، ظلمات بعضها فوق بعض. ومن الطبيعي أن تنحدر
الحياة الأدبية الرسمية في عصور التخلف وظلمات الجهالة وفقدان الذات، ويتولى الأدب
الشعبي مهمة التعبير عن هذه الحياة فيخرج صدى لما تعانيه الأمة العربية، ممسوخ
الخيال مريض التصور بعد أن شوهته عهود الظلم والتدهور، ويكون صورة صادقة لما في
نفوس الكبار المقهورة، وقلوبهم المكلومة، ونفوسهم المضطربة الخائفة، وحريتهم
السلبية، في قصص وأغان مليئة بالرعب والخوف، وحكايات ممزوجة بالألم والتعذيب
تنفيساً وإسقاطاً رمزياً. ونفذ ذلك كله وتسرب من نهر الأدب الشعبي للكبار إلى
الجدول الصغير من ((أدب الأطفال)). وعاشت الأجيال من الأطفال العرب الذين عاصروا
عهود الاضمحلال ونكبات الاستعمار يعانون من فقر التجربة وجدب العاطفة وتشويه
الخيال، ويقاسون من حكايات الرعب والخوف والفزع التي تسربت إليهم من قصص الكبار
فعاشوا تطاردهم أشباح شخصياتها المخيفة في الصحو والمنام.
في عصر
التنوير:
وبدأت النهضة العربية الحديثة. وأخذت الحياة في الأقطار العربية تتغير
صورتها رويداً ليعود إليها شيء من صفائها، وبعث التراث الأدبي، ودخلت البلاد في عصر
التنوير، ودبت الحياة فيما دون من التراث الأدبي الشعبي لعهود الازدهار، وانتشر
التعليم ثم رحل المستعمر. واجتاحت البلاد حركة ثقافية نشطة تعوض سني التخلف والجهل.
وكان التركيز كله منصباً على أدب الكبار وثقافتهم ولم يهتم أحد بثقافة الطفل وأدبه،
بل ظل سوء الطالع ملازماً للأطفال العرب، فأدبهم المبسط من أدب الكبار في عصور
الازدهار لم يكن مدوناً، ولم يلتفت إليه أحد من رواد حركة إحياء التراث الأدبي
الشعبي في أقطارنا العربية. فاختفى في رمال التاريخ وسقط من ذاكرة الزمن، ولم يبق
منه إلا النادر القليل الذي قاوم عوادي الدهر. وتوارثت كل منطقة عربية منه ما يعبر
عن جانب من الحياة فيها، أو يرسب معارفها، أو يحقق جزءاً من مواقفها
وعواطفها.
وشبت أجيال العصور الحديثة من أطفالنا العرب ورصيدهم من الحكايات
نوعان: القليل النادر من مخلفات الماضي المجيد والمبسط من قصصه الشعبي في عصور
الازدهار فيبعث فيهم روح المرح والمتعة، ويخلب ألبابهم بألوان الخيالات المبهرة،
ويفتنم بشخصياته الآسرة التي تشد إليها الصغار فيتعلمون منها خبرات الحياة وهي تعرض
الحق في بهائه، والعدل في قضائه، والصدق في صفائه، والجمال في روائه. لكن أكثر ما
يحكى لهم قصص تعبر عن عصور التخلف والتدهور والاحتلال، في صور من التراث الشعبي
ترمز إلى الظلم والاستبداد وقهر الرجال، فتبعث في قلوب الأطفال الخوف والاضطراب
وعدم الأمان، ويحسون ما فيها من ألم وعذاب، وتقلقهم أشباحها المفزعة بعدائها
وعدوانها، وتروعهم شخصياتها المخيفة بظلمها وجبروتها، من مردة تعذب الأطفال، أو
غيلان تخطفهم وتسجنهم في الظلام، أو سحرة أشرار يمسخونهم حجارة وحيوانات، أو آدميين
مجرمين يعذبونهم ويحرقونهم بالنار ويطبخونهم طعاماً للآكلين!!.
والعلماء متفقون
على أن الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة ـ قبل السادسة ـ يجب أن يجنب حكايات الرعب
والفزع والتعذيب والخوف، وكذلك القصص التي تحوي مضامين تنتهك التقاليد الاجتماعية
أو العواطف الدينية، أو تقلل من شأن القيم الوطنية والأخلاقية، لأن أطفال هذه السن
ليست لديهم خبرة بالحياة في هذا العالم، وتغلب عليهم السذاجة فيصدقون كل ما يقال
لهم ولا يفرقون بين الرمز والحقيقة. وحين تحكى لهم مثل هذه القصص يعيشون حياة ملؤها
الألم والعذاب، أو تهتز في نفوسهم القيم السائدة في مجتمعهم.
الأطفال بعد
السادسة:
أما أطفال السادسة وما بعدها، فقد اختلف العلماء في أن تحكى لهم قصص
تضم الرعب والخوف والفزع، وهناك من يرى أن مثل هذه القصص يجب أن تمحى من أدب
الأطفال، ذلك لأن الطفل ـ وهو أمل المستقبل وعلى عاتقه تقع مهمة التغير إلى الأفضل،
وإلى ما فيه خير المجتمع والانسان ـ يجب أن يتهيأ له المعين الذي يغترف منه الصدق
والحق والخير والعدل والأمن والمثل الأعلى الذي يجتذبه. ومن الظلم أن نطالبه
بالانطلاق إلى الحياة نموذجاً لانسان المستقبل ونحن نقطر في طفولته ـ عن طريق القصص
ـ ما يبعث في نفسه الاضطراب وعدم الأمان والإحساس بالظلم والمعاناة من الخوف والرعب
والذعر من الحياة. وانضم علماء النفس إلى هذا الفريق، واحتجوا على حكاية مثل هذه
القصص للأطفال، وكان تأثير هذا الاحتجاج أن أعيدت في أوروبا كتابة حكايات الجنيات
والخرافات المفزعة لتخفيف ما تحويه في أصولها المتوارثة من تفصيلات البشاعة
والتعذيب. ففي قصة (الغربان السبعة) من مجموعة (الأخوين جريم) مثلاً، وفيها الأخت
الصغيرة التي يتحتم عليها أن تقطع إصبعها لكي تتمكن من دخول القصر الفضي وتنقذ
إخوتها السبعة، عدلت القصة بحيث لا تشير إلى الألم أو الدم الذي سال من بتر ذلك
الاصبع.
والذين لا يجدون ضيراً من حكاية هذه القصص لطفل السادسة وما بعدها كما
هي دون تعديل، يؤمنون بأن القصص الشعبية تصور قدر الانسان ومصيره، وهي رمز للخير
والشر معاً كما يوجدان في الحياة، ويرون أن الطفل في سن السادسة لديه معلومات أكثر
عن العالم تؤكد له عن طريق الحقائق أن هذه القصص وهم وخيال. وفي نفس الوقت يقولون
إن الرعب في هذه الحكايات قد يكون عاملاً للتنفيس عن مشاعر الخوف والقلق الكامنة في
نفس الطفل، وذلك كما يحدث في قصة (الغربان السبعة) السابقة، فمن سياقها يمثل بتر
إصبع الأخت التضحية بها جزاء مسؤوليتها عن اللعنة التي أصابت إخوتها السبعة.
قصص
الخوف والفزع:
والعلماء الذين يبادرون بنقد القصص التي تقدم للأطفال عامة لأنها
تحوي الخوف والفزع لا بد لهم من أن يدركوا الأطفال لديهم مخاوفهم الخاصة بهم، وبعد
أن يقرأ أو يسمع طفل السادسة أحداث الفزع يجد الحنان والحب والأمن بين أهله فترتد
إليه نفسه الهلعة الخائفة، ويعرف أن ما سمعه أو قرأه إنما هو خيال كاتب أو قصاص لن
يمسسه منه سوء أو يصيبه من جرائه مكروه. وقد تكون الكتب التي تقرأ والقصص التي تحكى
هي الوسائل الأولى التي عن طريقها يتعلم الأطفال كيف يواجهون مصاعب الحياة ومشاقها،
ومن ثم لا بد أن يواجهوا هذه المصاعب في قصصهم لكي يعرفوا شيئاً عن آلام الحياة
وصعوباتها، وعن الرعب والقسوة والغدر في الحياة، وعن الحرب وما تخلفه من قتل وبؤس
وتدمير وشقاء، وعن الخيانة والحقد والخداع بوجوهها السوداء. وليس هناك من سبب
لحماية عقول الأطفال أو تدليلها أكثر مما ينبغي.
وقصص الأطفال الشعبية التي تضم
والفزع والتعذيب ليست وحدها التي يجب أن نجنب الأطفال سماعها في المرحلة المبكرة،
بل هناك نوع آخر أكثر خطراً على وجدان الطفل وتكوين عواطفه تجاه دينه ومجتمعه
ووطنه، تلك هي القصص التي تحوي مفاهيم تنتهك تعاليم الدين، أو تستهين بالتقاليد
الاجتماعية الأصلية أو تحبط النزعة الوطنية في نفسه، وتتمثل في سلوك شخصيات القصة،
فتترسب في ذهن الطفل وتستقر في وجدانه وعواطفه. والطفل وهو مستغرق في سماع الحكاية
لا يكون مدركاً قوة التأثيرات التي يستجيب لها لأنها تحدث دون شعور منه، وذلك
بواسطة عقله الباطن الذي يعي السلوك والتجربة من أحداث القصة أو من سلوك شخصياتها.
ويقوم الطفل بعملية توحج مع الصور والنماذج المعروضة في القصة، ويميل إلى محاكاتها
وتقليدها، ويتأثر بما يسمع فينمو لديه الخيال المريض ويكسبه المعاني السيئة، ويثير
في نفس القلق والشك والاضطراب ونزعة الاجرام حين يقوم بعملية موازنة ومقارنة بين ما
يسمع من القصص وما يرى في واقع المجتمع الذي يعيش فيه. وإذا كان الطفل سريع التأثر
بما يحيط به من مؤثرات مختلفة وتتكون اتجاهاته ومثله وأهداف الحياة عنده في مرحلة
طفولته، فتجاربه الذاتية مما يسمع ويقرأ لها أهمية كبرى في مستقبل حياته.
في
الخليج العربي:
وإذا استعرضنا ما يحكى اليوم للأطفال في منطقة الخليج العربي من
التراث الأدبي الشعبي نجده يضم بين ما حملته الأيام من أعماق التاريخ حكايات
الجنيات والسحرة، والقصص الشعبية، وحكايات الحيوان، والأغاني، والأحاجي، وحكايات
البحر، والحكايات الدوارة، وقصص الأذكياء والحمقى وغيرها من صنوف الحكايات الشعبية
المختلفة. هذه الحكايات التي ما زال الكبار يروونها للصغار حتى هذه الأيام جديرة
بالدراسة لبيان ما يصلح منها للأطفال وما لا تصلح حكايته لهم.
وجمهور العلماء
والباحثين في التراث الأدبي الشعبي يطلقون مصطلح (حكايات الجنيات والسحرة Fairy
Tales على القصص التي تدور حول الجنيات أو المخلوقات التي فوق مستوى البشر، ومع ذلك
فالمجموعات المختلفة من هذه القصص لا توجد الجنيات إلا في عدد قليل منها. ومن ثم
أطلق جوزيف جاكوبس هذا المصطلح في مقدمته لكتابه English Fairy Tales على القصص
التي تحدث فيها الخوارق أو الأمور الغريبة، كأن يكون فيها جنيات أو عمالقة أو
أقزام، أو حيوانات تتكلم، أو يكون فيها عمل غير طبيعي كالحمق والغباء. وأطلقت روث
توز هذا المصطلح في كتابها Story telling على القصة التي كتبها مؤلف واحد، وتدور
حول قوى سحرية أو خارقة تحقق الآمال والأحلام، وهي في رأيها غير القصة الشعبية لأن
القصة الشعبية مجهولة المؤلف، أو يتعدد مؤلفوها.
وفي عصرنا الحديث لا يمكن لأحد
أن يفكر في طفل وحكاية دون أن يفكر في قصص الجنيات والحكايات الخرافية. ترى أهي
عادة سيئة خلفتها لنا ـ فيما خلفت ـ البدائية الأولى؟ أم أنها رواسب من تفكير
العصور القديمة ومعتقداتها؟ أم أن هذه الحكاية تستطيع أن تبرر علمياً شهرتها
وذيوعها بين الأطفال، وأن تثبت أن حب الأطفال وشغفهم بها له نتائج تربوية مؤكدة؟
وهل يمكن أن نزعم ونحن في عصر الأقمار الصناعية وعصر التقدم في بحثو علم نفس الطفل
وطرق تربيته أنها بوجه عام قصص تلائم الأطفال في هذا الجيل وتصلح أن نقدمها
لهم؟.
نعم، إن حكايات الجنيات الخالية من الفزع والخوف وقتل الأطفال وتعذيبهم
والتي استطاعت عبر هذه القرون الطويلة أن تحتفظ بحب الأطفال لها، وأن يشتد ولعهم
بها في عصور مختلفة التطور والحضارة، لا بد أنها تحوي في جوهرها من عناصر الحياة ما
يجعلها قادرة على تلبية كثير من حاجات الطفولة. فالعجوز المسكينة التي تستند بيدها
المرتجفة على عصاها السحرية تستطيع بحركة من هذه العصا أو بكلمة مرتعشة من فمها
الخالي من الأسنان أن تبعث في الأطفال روح المرح والمتعة، تلك التي نبذل نحن الكبار
قصارى جهدنا لنحركها فيهم ونجوه مشاعرهم نحوها! ويمكنها كذلك أن تقرع بعصاها
السحرية الأبواب المغلقة فتنفتح على كل ألوان الخيالات العجيبة المبهرة والمغامرات
الآسرة التي تخلب لب الطفل وتقتنه، وتشد إليها خياله فيحلق في عالم جديد تنتفح له
تصوراته ومدركاته، ويشارك في الأحداث، وينفعل بالعواطف، ويستمتع
بالغامرة.
وحكاية الجنيات تلائم أطفال عصرنا ـ عصر الأقمار الصناعية ـ وتلبي
كثيراً من احتياجاتهم الخيالية العاطفية وسط عالم طغت عليه المادية وتفيدهم من طرق
شتى، ومن ذلك قدرتها المتميزة على عرض الحق والعدل والصدق والجمال والخير في ثوب من
الخيال والتصور، وذلك هو الطريق الذي اتخذه جنس الأطفال تجاه الحكمة، والذي تسلكه
الفطرة والغريزة لكل طفل ميراثاً من براءة الطفولة واستجابتها الفطرية للحق والصدق
والعدل.
كذلك تعرض كثير من حكايات الجنيات الحقائق الأولية لقانون الحق والخير
والعدل في صورة متخلية من تجارب الانسان. ومع أن الطفل حين سماعه القصة لا يدرك إلا
الخيالات لكن الحق والتجربة يمتزجان بوجدانه ويصبحان جزءا من تجربته الشخصية،
يميزهما في المراحل التالية من حياته حين يتعرض فيها لمواقف مماثلة، كما تضيف
عنصراً جديداً لمخزونه من الاستنتاجات ولرصيده من الأخلاقيات يستخدمها ويتعامل بها
في حياته المستقبلية. وفوق ما تحويه من صور الحق والعدل والتجربة، فإن شخصياتها
الرئيسية تتميز بالخصال الحميدة من شجاعة وشهامة وأمانة ووفاء، كما أن فيها من
الآثار والذخائر والتراث ما يصل الطفل بألوان الفنون الشعبية لأمته، وهذه عناصر
ضرورية تدخل في تكوين الذوق الفني لكل انسان. ومع ذلك فهذه الأسباب وغيرها تأتي
تبعاً للغاية الكبرى من حكاية قصص الجنيات للأطفال وهي تسليتهم وإمتاعهم وإدخال
السرور عليهم. وقد لازمتها هذه الغاية من أول الزمان إلى عصرنا الحديث، لم تتخل
عنها إلا في فترة الاضمحلال والتدهور والاحتلال والاستبداد وظلمة الفقر والجهل،
فترة فقدان الذات التي خرج الخيال فيها ممسوخاً والتصور مريضاً مشوهاً في قصص وأغان
مليئة بالرعب والهلع والخوف، وحكايات ممزوجة بالألم والتعذيب تنفيساً وإسقاطاً
رمزياً. وحكايات هذه الفترة الظملة هي ما يتحتم أن نجنب الأطفال الصغار سماعها، كما
يتحتم ألا نقصر الحكايات التي نحكيها لأطفالنا على قصص الجنيات وحدها، بل نقدمها
لهم لوناً من ألوان التسلية مع غيرها من القصص التاريخية والعلمية والبطولية وغيرها
من قصص الأطفال. وسوف يدرك الطفل أن قصص الجنيات إنما هي وهم من خيال وتصور |  مخيمات الاشبال والزهرات الصيفية نهج تربوي وملاذ ترفيهي لاشبال وزهرات فلسطين
مخيمات الاشبال والزهرات الصيفية نهج تربوي وملاذ ترفيهي لاشبال وزهرات فلسطين كلمة أشبال وزهرات فلسطين في ذكرى الإنطلاقة
كلمة أشبال وزهرات فلسطين في ذكرى الإنطلاقة  مؤسسة الاشبال والزهرات عطاء بلا حدود
مؤسسة الاشبال والزهرات عطاء بلا حدود كيف نحفز الاطفال على المشاركة والعمل المجتمعي الهادف في ظل انتشاء وباء كورونا
كيف نحفز الاطفال على المشاركة والعمل المجتمعي الهادف في ظل انتشاء وباء كورونا 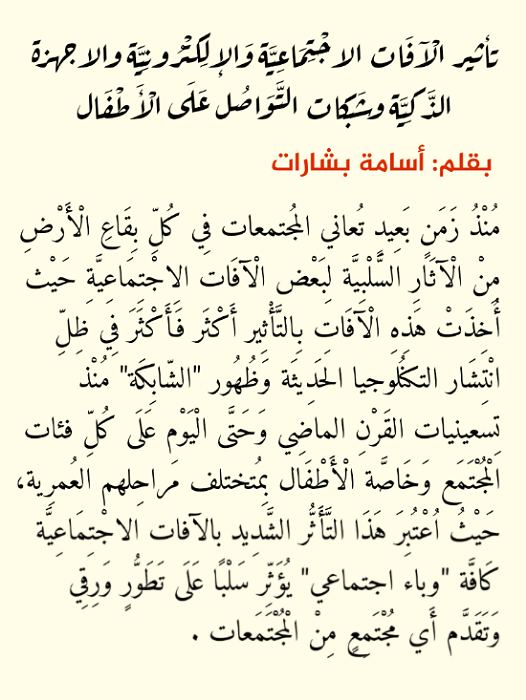 تأثير الْآفَات الاجْتِمَاعِيَّة وَالإلِكتْرُونِيَّة والاجهزة الذَّكِيَّة وشَبكات التَّوَاصُل عَلَى الْأَطْفَال
تأثير الْآفَات الاجْتِمَاعِيَّة وَالإلِكتْرُونِيَّة والاجهزة الذَّكِيَّة وشَبكات التَّوَاصُل عَلَى الْأَطْفَال






